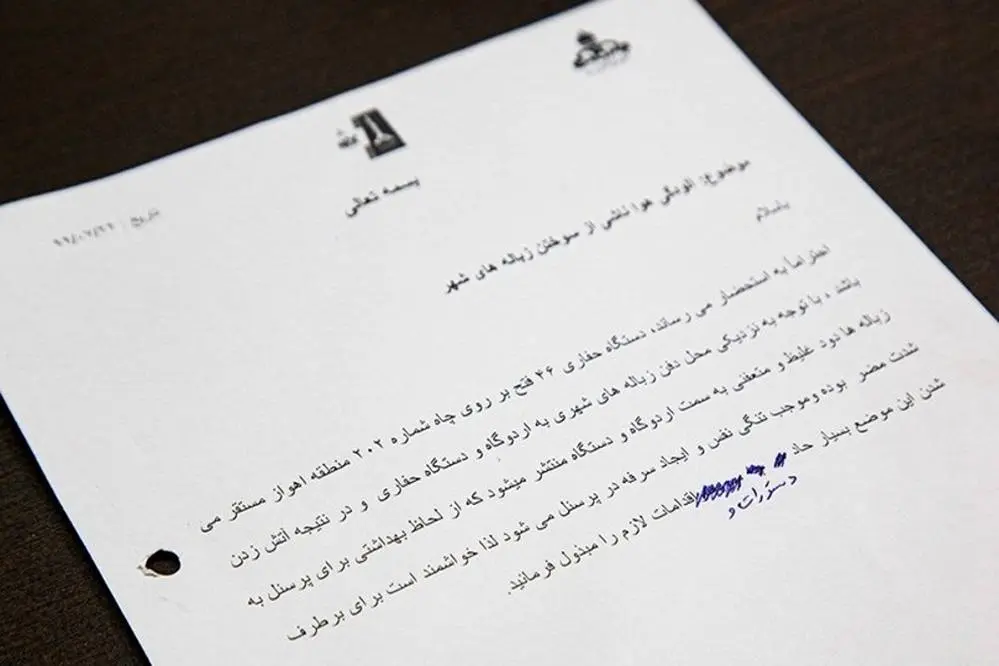مشهدٌ لا يفارق قرى الغيزانية، شرق مدينة الأحواز: أنابيب النفط والغاز تحاصر بيوت السكان، على بعد أمتار قليلة. خطرٌ مستمر، يتجدد مع كل يوم يمر دون أي اعتبار للمخاطر الجسيمة التي تهدد حياة الأحوازيين. لم يعد الأمر مجرد احتمال، بل أصبح واقعاً ملموساً، يتجسد في كل حادث، في كل شكوى. العام الماضي، دفع ستة أشخاص ثمناً باهظاً لهذا الإهمال، ضحايا انفجار أنبوب نفط. لم يكونوا من أهل الغيزانية لكنهم لقوا حتفهم على أرضها، كشاهد جديد على حجم الخطر المحدق. وفي كل مرة يتكرر التبرير الرسمي: “الأنابيب متآكلة وصدئة”. تبريرٌ بات غطاءً لكل مأساة يعيشها الأحوازيون في الغيزانية. تلوثٌ يقتل، فقرٌ ينهك، وأراضٍ تسلب بالقوة، كل ذلك تحت ذريعة “تآكل الأنابيب”. هذه ليست مجرد حوادث متفرقة، بل هي صورةٌ متكاملة لحياةٍ يعيشها عشرات الآلاف من الأحوازيين في قراهم، حياةٌ تتسم بالسلب والفقر والتلوث والمرض، في ظل سلطة استعمارية تستغل ثرواتهم وتتنكر كل حقوقهم وتنتزع كرامتهم وإنسانيتهم.
الذهب الأسود وشقاؤه
عقود أربع مضت على نشاط الصناعة النفطية في الغيزانية. فمنذ اكتشاف النفط لغاية الآن تحولت هذه الصناعة إلى بلاء ينخر أرواح القاطنين في الغيزانية قبل أبدانهم، بكل ما في هذه الصناعة من ثروات وتلوث وشقاء وتمييز. فما إن بدأ هذا النشاط حتى تعطلت الزراعة واستحالت، خاصة في الصفيرة إحدى قرى الغيزانية، وهي تضم أكبر الحاويات للنفايات النفطية والبتروكيماوية.
فهنا يترقب الأهالي، أهالي الصفيرة، حقولهم الزراعية بفارغ الصبر، لتنمو المحاصيل فيأتي حصادها وقطفها، موسم كان يعني الخير والعطاء في الحياة القائمة على الزراعة، ويرمز إلى استمرار الحياة، وتوريثها إلى الأبناء. ولكن ذلك كله أصبح أملًا واهيًا بمياه نزع الأملاح. وتلك عملية لم يسمع بها أحد من أهالي الغيزانية، وربما الكثير من الشعب الأحوازي (ونحن منهم). إنها عملية لتصفية النفط. يتم فيها خلط النفط بالماء لإزالة الأملاح من النفط الخام، تستخدم في معظم المصافي. ولكن هذه المياه غير بريئة، إنها مياه شؤم، كلما تسربت من المصانع النفطية ومصافي التكرير إلى الحقول، جلبت معها الأضرار وقتلت الحياة. هنا لا يرى الناس من الأنابيب والنفط سوى كوارثه: مياه ملوثة تأتي وتجري، وغبار ودخان من مشاعل الغاز التي تشتعل بالقرب، وتلوث لا يفرق بين شيء، و يتعمم على الصحة والأبدان قبل الحقول الزراعية والمياه.
فهذه قصة حمدان، الطفل الذي ولد مشوهًا من رحم الأم التي مرضت بفعل مياه مملوءة من المواد النفطية، فأورثت ما أصابها إلى ابنها. ولد حمدان بكلية واحدة، لا تعمل سوى 37 بالمئة، لون بشرته يميل إلى اخضرار بسمار، وأكتاف غير متعادلة جعلت يده اليمنى تبدو أطول من اليسرى. وبعد أن بلغ السابعة من العمر، توقفت كلية حمدان كليًا، وأصبحت حياته رهنًا لمراجعة الطبيب من أجل تصفية دمه. لا تمتلك الأسرة المال اللازم لذلك، والمنظمات الداعمة تتلكأ في توفير الدعم له. أما أمه الشابة، هي وحدها التي تتحمل معاناة رعاية ابنها البكر، تأتي به من الغيزانية الفاقدة لأي مستشفى، إلى العاصمة الأحواز، على بعد 30 كيلومتر، كيما تصل به إلى مركز تصفية الدم. امتنعت أمه عن إنجاب طفل آخر، لأنها أصيبت بصدمة جعلتها تخشى إنجاب طفل آخر قد يكون مصابًا كحال ابنها.
لا تقتصر إفرازات هذه الصناعة على مياهها منزوعة الأملاح فقط، وما تجلبه للبشر، بل فيها من الحالات الكثيرة نظير تصاعد غيوم من الملوثات تصل إلى العاصمة الأحواز، ليستحيل فيها استنشاق الهواء. وفي يوم من الأيام ثُقب أنبوب، فجرى منه سائل أسود، خليط من ملوثات النفط والمياه والزيت، وصل إلى الحقول فحولها إلى خراب شامل. إنه أنبوب رقم 4 لشركة كارون للنفط والغاز العملاقة، أنبوب الموت والدمار.
ويقول أحد المسؤولين في النظام الإيراني بأنه عندما ثقب أحد أنابيب النفط، تسرب منه سائل من المياه والنفط، فتسبب ذلك بحفرة تكدست المياه فيها، فتحولت إلى بحيرات صغيرة، ما إنْ هطلت الأمطار حتى امتزجت بها، فوصلت إلى الحقول الزراعية وأصابت بساتين النخيل وحقول القمح والشعير، فأتلفت المحاصيل. كما يصرح مسؤول آخر بأن هذا التلوث الصادر عن الشركات ومصانعها، تسبب بأمراض مختلفة لأكثر من ثمانية آلاف شخص حسب إحصائيات أولية. وفي مقدمة هذه المناطق التي تعاني من كل ذلك بالطبع، هي قرية الصفيرة التي لا تبتعد عن الأحواز العاصمة سوى 30 كيلومترًا.
أطفال يختنقون ونساء محتجزات لقد حوّلت السلطة الاستعمارية الإيرانية حياة سكان قرى الغيزانية إلى جحيم حقيقي؛ فقد قتلت التربة، ولوثت الهواء، وسممت المياه، وسلبت مصادر العيش ودمرتها، وتوجت كل ذلك بالاعتداء على أبدانهم وصحتهم، فشوهتها وجعلتها عليلة مصابة. وأكثر الفئات تعرضًا إلى تبعات هذا الجحيم، كانت الأمهات والأطفال، لأنها تمكث عادة في البيوت أكثر، الأمر الذي جعلها عرضة لمخلفات هذه الصناعة. فهذه الفئات تتنفس صباح مساء ذلك الهواء المحمل بجزيئات كيميائية تتطاير في الهواء وتدخل الرئات. تجد عيون الأطفال مُحْمَرَّة، يعانون حكة في الجسم. لا يعلم الأطفال بأن خروجهم عن البيت يساوي الموت، يساوي قصر العمر، ومعاناة سترافقهم إلى باقي حياتهم التي قد لا تطول. فتراهم يهرعون إلى الخارج إلى اللعب والجري، رغم محاولات ذويهم منعهم من الخروج عن البيت، خوفًا عليهم واتقاءً لشر التلوث المحدق.
وتشير تقارير المدارس في الغيزانية إلى حجم الإصابات بين الأطفال، خاصة الإصابة بالحكة والربو. إلى جانب إصابة أمهاتهم أصلاً. فهذه صبيحة البالغة من العمر عشرين عامًا، وهي ضحية من آلاف الضحايا، أصيبت بربو وضيق النفس. وقد نصحها الأطباء بعدم الخروج من البيت، لأن ما أصابها هو نتيجة للتلوث واستنشاق الهواء الملوث. صبيحة ليست سوى عشرات النساء اللاتي أُصِبْنَ بأمراض التلوث، بين عقم عن الإنجاب، وسرطانات في البشرة، وتساقط الشعر، وضيق النفس. ونظرًا لطريقة حجاب النساء وفق الثقافة العربية، تكون أيام الصيف الجحيم الحقيقي لأجسام النساء، حر وراء خمار وثياب طويلة، سوداء اللون، وتلوث في الهواء، يجعل كل امرأة تحمل تحت خمارها العذاب بأشد طرقه.
في قرية الصفيرة، لا يقتصر التلوث على مجرد رائحة كريهة أو سماء رمادية؛ إنه رفيق بغيض يومي يلتصق بصدور الأطفال ويحجز النساء في منازلهن. هنا، الربو ليس مجرد مرض، بل هو لعنة فرضتها أنابيب النفط وشاحنات القمامة، تاركة خلفها كل السكان يعانون.
مثل العديد من نساء قريتها، تعاني حميدة من صعوبة في التنفس ونزيف في الأنف منذ ثلاث سنوات. تقول وهي تجلس داخل منزلها المغلق النوافذ: “يقول الأطباء إن السبب هو التلوث، ولذلك لا أستطيع الخروج من المنزل على الإطلاق.” حميدة، وهي في الأربعينيات من عمرها وأم لثلاثة أطفال، أصبحت محتجزة في بيتها، تخشى أن يستنشق أطفالها الهواء الملوث الذي يملأ القرية. “نحن النساء محبوسون في منازلنا، ونعاني من تساقط الشعر والربو والالتهابات والتشققات والتقرحات الجلدية المنتشرة بيننا وبين أطفالنا بشكل واسع.”
لا تقتصر المعاناة على حميدة؛ تعاني أغلب نساء القرية، حتى الشابات دون الثلاثين، من ضيق في التنفس. “أخبر الطبيب الكثير من الأشخاص، مثلي، أنهم مصابون بالربو،” تضيف حميدة.
هذه الأمراض التي لم تكن منتشرة سابقاً أصبحت الآن جزءاً من الحياة اليومية. مصدرها، كما يقول السكان والأطباء، واضح ومؤلم: أنابيب النفط التي تسيطر على أراضي القرية، وشاحنات القمامة التي استقرت هنا، محولة القرية إلى مكب نفايات.
يظهر تأثير هذا التلوث بشكل قاسٍ على الأطفال. يشتكي الصغار لأمهاتهم من حرقة في صدورهم وعيونهم وحكة شديدة في جلدهم. غالباً ما تكون عيون الأطفال حمراء وأجسادهم تعاني من الجروح والالتهابات نتيجة الحكة المستمرة. في مدرسة القرية، يعاني أكثر من 50 طالباً من الحكة وحرقان الجلد، بالإضافة إلى انتشار الربو بينهم. “لدينا مدرسة، لكن الأطفال غالباً ما يعانون من جروح في أجسادهم،” تقول حميدة بقلق. يجمع الأطباء على أن السبب الرئيسي لهذه المعاناة هو تلوث الهواء. “ما هي خطيئة الأطفال؟” تتساءل حميدة بمرارة.
في هذه القرية، مثل كل القرى الأحوازية المجاورة، لا يوجد فرق بين المواسم. سواء كان الربيع أو الخريف أو الشتاء، تنتشر رائحة كريهة لا تطاق في كل مكان. الأراضي الزراعية الخصبة التي كانت يوماً مصدراً للرزق تحولت إلى ممرات لأنابيب النفط.
يروي غانم باوي، وهو أحد سكان القرية، قصته المؤلمة: “كنت مزارعاً، لكن تسرب النفط من الأنابيب أدى إلى تلويث معظم أراضي القرية، ولم تعد تنبت بذور القمح في أرضي. الآن أصبحت حارس أمن لشركة النفط، أتقاضى راتباً بالكاد يكفي لدفع تكاليف تعليم أطفالي وتغطية نفقات المنزل.”
البطالة مشكلة متفاقمة أيضاً. “تخرج ابني من الجامعة وبقي عاطلاً عن العمل. الشركة لم توظف شباب القرية حتى لو كانوا يحملون شهادات جامعية. الكثير من الناس هنا عاطلون عن العمل، ولأن شركة النفط تمارس التمييز ضد العرب ولم توظف شبابنا، استحوذ المستوطنون الفرس على أغلبية العمل والمناصب.” وينهي كلامه بسؤال: “متى سينتهي هذا الكابوس؟”
تحيط منزل صبيحة، الأم لثلاثة أولاد، حاويات النفايات، حيث تفرغ شاحنات القمامة حمولاتها بالأطنان يوميًا، مما يدفع الأطفال الذين يلعبون بالجوار للهروب، بعد أن حذرهم آباؤهم من الاقتراب خوفًا من التلوثات الكيميائية. فبمجرد وصول الأطفال والبنات إلى قرب هذه الحاويات المتنقلة، يصابون بحكة في العيون، وضيق في الصدر، وحكة في الجلد، ومختلف الأعراض. ولم تراعِ شركة النفط في مدها للأنابيب حدودًا معينة تنشط فيها، بل خططتها بناءً على مصلحتها المالية، فأصبحت أنابيب النفط تمر من قرب البيوت والقرى والمناطق المأهولة بالسكان. وهكذا قتلت إمكانية الزراعة ليتحول المزارع السعيد بالأمس، إلى عامل يشقى بالاستغلال والفقر المدقع في شركات النفط، ينظف ويأتي بالمرطبات للموظفين الفرس، ويفعل كل ما ينال من الكرامة من أجل المستوطنين المُنْعمين بخيرات النفط، التاركين شقائها للأحوازي العربي. وبينما كان سعيد أبا أمجد مزارعًا مستقلاً، حولته العمالة إلى خادم عند شركة خاصة، يمتلكها أبناء أحد المستوطنين، ممن يعمل أبوه مديرًا كبيرًا في إحدى فروع شركة النفط. فهذا المدير لا ينظر إلى أبا أمجد كما كانت تنظر له الناس باحترام، وصاحب أرض وملك يكفيه ويكفي أسرته اقتصاديًا ويحفظ شأنه وكرامته، بل يراه فقيرًا عاملاً غير متعلم، لا يساويه في المنزلة الإنسانية. ففي إحدى المرات نادى أحد المديرين الفرس في الشركة الخاصة التي كان يعمل فيها أبا أمجد، وأعطاه كيسًا، قال خذه لك. فلما فتحه أبا أمجد رأى فيه كيس أرز، وثياب أطفال مستعملة. وفي المقابل، كانت ردة فعل أبا أمجد مؤلمة، فقد انتابه شعور قاسٍ بالإهانة، ففي الوقت الذي كان يُفترض به أن يكون في موقع مهني، وجد نفسه وكأنه متسول تتقاذفه الصدقات على مضض. وبينما كان الشعور بالذل يكبله، لم يجد أمامه سبيلاً للرد أو الاعتراض. هذه التراجيديا دفعته إلى الصمت القسري، وهو يخشى أن يكون الثمن هو إبعاده عن عمله.
ومن المفارقة أن يوصف العامل الأحوازي، بأنه ذو حظ، رغم كل ذلك، لأنه هرب من البطالة إلى العمل، وذلك لأن حال الأكثرية في الغيزانية وأمثالها، هي البطالة والفقر، بعد أن سويت الأرض بالدمار والتلوث، وتعذر الزرع والفلاحة بموت الأراضي وتدميرها. وقد جعل هذا الفقر المدقع إثر تدمير الأراضي الزراعية، جعل الناس تفكر مليًا في الهجرة من الغيزانية، وتركها للمستوطنين وصناعتهم النفطية وخيراتها. وقد عزز ذلك هذا التفشي المخيف للأمراض، ورؤية مرض الأطفال وإصاباتهم، وعيونهم المحمرة وبشرتهم التي تتآكل، وصحتهم التي تتردى. وليس من مصير أمام هؤلاء المفقرين، المعززين بالأمس في بيوتهم وحقولها وخيراتها ووفرة نعمتها، سوى اللجوء نحو الهوامش نحو حاشية المدن، والمكابدة بكل ما فيها من انعدام خدمات ومياه ملوثة وجرائم وبطالة وفقر مدقع.
وغريب أمر هؤلاء العرب المتحصلين على مناصب حكومية في أجهزة الاحتلال، كيف يتنصلون من أدنى مسؤولياتهم، ويتعرون عن إنسانيتهم، فيتنصلون عن كل ما يمت لأهلهم وذويهم بصلة، ينكرون تعرض شعبهم إلى الإبادة، وينكرون التلوث، سعيًا لجلب رضا أسيادهم المستوطنين الفرس. وهكذا ينكر مسؤول الغيزانية العربي وغيره من المسؤولين في باقي المدن، مصائب الشعب الأحوازي من ملوثات النفط، وينكرون تفقيرهم، ملقين باللوم على أنفسهم في جلد ذاتي لا يرحم، يجعل من الضحية ظالمًا ومجرمًا. فعندما يرى هؤلاء تكدس النفايات النفطية، إلى جانب تكدس المخلفات البلاستيكية غير القابلة للتكرير، لا يلقون بالمسؤولية على الحكومة وأجهزتها، بل يذهبون يبررون ذلك بأن العرب لا يلتزمون بالنظافة، وأنهم متسخون! إنها الأسطوانة المتكررة التي يلقي العرب باللوم على أنفسهم، خاصة أهل المناصب الدنيا هؤلاء، خشية على فقدان فتات ما لديهم.
وعندما جاءت جحافل الفرس تبحث وراء النفط، فسلبت الأراضي العربية، وحقول المواطنين العرب، ظن هؤلاء العرب المسلوبين بأنهم سيتحصلون على عمل في شركات النفط، عوضًا عن أراضيهم التي سلبها الاحتلال لصالح الشركة، متأملين عملًا كريمًا في شركة النفط. ولكن خابت أحلام من حسن ظنه بالاحتلال. فكانت المعادلة مصادرة أرضك الزراعية ومصدر رزقك، مقابل ملوثات النفط، وتدهور صحتك، وسرطان لأولادك وبناتك، وفقر مدقع يجعلك تفتقد الخبز والمياه الصالحة للشرب، لأنها مياه لوثها النفط أيضًا. أما شركة النفط فهي من نصيب المستوطنين الفرس، من اللر، جعلت العربي الأحوازي يعبر عن معاناته بنكتة يكثر تداولها تسمى «شركة النفط الوطنية» بـ شركة اللر الوطنية، لأنهم هم المستوطنون، وهم المحتل، وهم من جلب كل الويلات إلى الشعب الأحوازي، بدعم وتوجيه وتخطيط من جانب سلطات المركز.
ولقد بلغ استهتار هؤلاء المستوطنين بحياة العرب، الشعب الأحوازي، مستويات تخرجهم عن الإنسانية، وتسلبهم الطبيعة البشرية. فهؤلاء عندما أرادوا مثلاً العثور على طريقة يتخلصون بها من نفايات شركة النفط، اختاروا أقصر الطرق، الطرق التي تنم عن جهلهم بالعمل اللازم لإدارة الصناعة النفطية: أتوا بالنفايات فأشعلوها بالقرب من البيوت والمزارع، ليتخلصوا منها، غير مبالين بما ستتسبب به من تبعات بيئية وصحية على الأهالي، وكيما لا يضطروا تسديد تكاليف دفع النفايات وفق معايير السلامة.
عملية ينفذونها كاللصوص في جنح الظلام، فيكون الليل، ليل العرب وسوء طالعهم باحتلال يفتقر لأدنى صفات الإنسانية والبشرية وأدنى رحمة، ليل غيوم ودخان، يشبه حربًا نفسية قاتلة، تسلب إمكان النوم، وتضيق النفس على كل فرد يرقد في القرب؛ لأن الناس لا تقدر أن تنام في هذه الحالة، وهي تشم رائحة نتنة يختنق فيها البشر ولا يمكنه التنفس. غيوم من الدخان الأبيض الذي يصل إلى الأحواز العاصمة نفسها، من شدة اتساعه. وبينما تأتي منظمة الحفاظ على البيئة للمواقع لتفقد طريقة التخلص من النفايات، فكأنها تأتي من أجل جباية الضرائب:فهي لا تأتي للتأكد من تطبيق معايير السلامة في العمل، بل هي تأتي لتجمع رشاوى شركة النفط الثرية لها، حتى تحول العاملين في هذه المنظمة إلى أثرياء من كثرة التقاضي عن تخلفات شركة النفط البيئية مقابل دفعها الرشاوى لهم.
التمادي في العدوان
لم يكن تلوث البيئة الناتج عن عمليات شركة النفط الإيرانية في الغيزانية هو الضرر الوحيد الذي لحق بأهلها. بل تجاوز الأمر ذلك ليطال البنية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة. فالسلطات الإيرانية، التي تجني أرباحاً طائلة من هذه الثروة، وسعت مشاريعها على حساب حياة السكان، فصادرت الأراضي الزراعية التي يعتمد عليها الأهالي في معيشتهم. وهكذا تم تحويل هذه الأراضي إلى طرق ومصانع وأنابيب نفطية، ليجد أهالي الغيزانية أنفسهم محاصرين بين التلوث وتدمير سبل العيش. هذا الواقع الاستعماري الذي فرضه الاحتلال الإيراني جعل من المستوطن الغني سيداً، ومن الشعب الأحوازي في الغيزانية عبدا، شعباً سلبت منه أرضه وحياته وكرامته.
وعند تنفيذ مشاريع توسيع الحقول النفطية ومصانعها وشركاتها على حساب بيوت الشعب الأحوازي في الغيزاينة وحقولها، ضلّل الاحتلال السكان بإيهامهم بأنهم سيحصلون على تعويضات عن كل قطعة أرض تم ضمها لمشروع شركة النفط. ولكنها كانت خدعة ليس أكثر، حين أناط الإحتلال الحصول على التعويضات للمزارعين ممن سلبهم أراضيهم، بالتداول الإداري. والتداول الإداري بعيد الأمد بطيء التنفيذ، يحتاج إلى معرفة قانونية بشبكة القوانين الحكومية والإدارية. وهكذا طال أمد استيفاء التعويضات، وتعب وأُهين المزارع، وبعد سنوات طوال أتى البت بالموضوع نهائيًا: لا تشملكم التعويضات بناءً على القوانين. وهكذا خرج المزارع بعد سنين من الانتظار والمراجعات والمتابعات، بل ومن التكاليف الخاصة بالنظام الإداري، خالي اليدين. هذا حال حجي سالم، أحد مئات الأحوازيين الذين فقدوا أراضيهم. بعد سنوات من المتابعة في إدارة التعويضات، أبلغته الجهة المعنية (جهاد كشاورزي) بأن التعويضات لا تشمله… وانتهى الأمر. نهاية تعني له بداية الفقر والضياع.
وأكثر من ذلك هو قصة باقي الأراضي، التي بقيت بيد أصحابها. فهنا مُنِعَ هؤلاء من الأمل الخداع أيضًا. حيث لم يكونوا أمام سلب ناعم للأراضي وأمل في منح تعويضات، بل دمرتها شركة نفط المستوطنين بليلة واحدة، عندما تسربت مياه من الأنابيب الصدئة المثقوبة إلى الحقول، فقتلت المحاصيل، وجعلت الأرض خربة لا ينمو فيها شيئًا حتى أجل غير مسمى.
أينما حلت شركة النفط قتلت الأراضي الزراعية للشعب الأحوازي، وقضت على مصادر الرزق قضاءً حتميًا. ونظرًا لاستناد القرى والأرياف الأحوازية على الزراعة والاقتصاد التقليدي، يعني إخراج هذه المصادر عن وظيفتها، قطع مصدر العيش الوحيد للناس. وتتكفل بمهمة قتل الأراضي الأنابيب البالية التي تفرز ملوثات لا تطال صحة الأبدان فحسب فتقضي عليها، بل تحول الأراضي الخصبة إلى أراض قاحلة لا ينمو عليها ثمرًا. وتكون الطامة الكبرى عندما تحدث ثقوب في هذه الأنابيب، فيترك الأمر عن عمد لأيام وأسابيع حتى يرأب صدع الثقب. وحينها يكون الثقب وما تسرب عنه، قد فعل فعلته، وأصاب ما أصاب: نفط ملوث ونفايات النفط غير المكرر إلى أراض واسعة، قد تصل إلى هكتارات.
إن ما يثير استغرابا كبيرًا، ويدل على توغل الاحتلال في الظلم وعدم اكتراثه مطلقًا بحياة الشعب الأحوازي، هو تحويل 125 هكتار من الأراضي العامرة الخصبة من أراضي الغيزانية على مقربة من الأحواز العاصمة، إلى مكب للنفايات، مختلف النفايات السامة والضارة والكيميائية والخاصة بالمشافي إلخ، تحديدًا في الصفيرة، تلك المنطقة الجميلة الخلابة التي كانت تسر الناظرين، فتحولت إلى عفن متطاير، يعيش أهلها بين السرطان والفقر والتهجير. لقد لوثت هذه المساحة المأهولة من النفايات، التي لم يراعِ دفعها أدنى شروط الالتزام بمعايير التكرير، الهواء بشكل كبير، حتى تحولت إلى ما يشبه بؤرة كيميائية، ومصدر الأمراض والأوبئة، في قلب الغيزانية وفي مركز أهلها وقراها. ولا شك بأن الحبل على الجرار لباقي المناطق الأحوازية، فبعد أن كانت منطقة البرومي هي مكب نفايات صناعات النظام الإيراني، وبعد أن دمر الحياة فيها ودمر أهلها مرضًا وفقرًا، زحف إلى الصفيرة، فحولها إلى دمار، ثم سيزحف هكذا إلى باقي المناطق، ليحول الأحواز إلى موت أحمر.
هذه الأنابيب مقدسة لدى الشركة لا يستطيع أحد المساس بها. هي أقدس من أرواح الشعب العربي الأحوازي، وأقدس من حرمه وبيته؛ لأنها أنابيب المستوطنين التي تجلب لهم المال. المستوطنون أقدس من العرب وأعز، ودليل قداستهم في أنفسهم: فهم بشركات نفطهم، قتلوا النساء والأطفال العرب، دون أن يسألهم أحد، أو يقاضيهم… هم جلبوا للشعب العربي أنواع الأمراض والسرطانات والتشوه الخلقي، دون أن ينصفهم أحد ويطالبهم بالرفق والرحمة… هم أفقدوا حميدة شعرها الطويل المجعد وأصابوها بضيق النفس، وسلبوا كرامة أبا أمجد ورموه فراشًا في شركة خاصة يتصدق عليه الفرس، ولم يَثُر عليهم أحد… وهم أصابوا عيون حمدان الجميلة العربية والطفل المشاكس بالرمد، ولم يفزع له أحد… إنهم فعلوا… وأصابوا… وجلبوا… وقتلوا… ونهبوا… ولم يحدث شيئًا. إذن هم مقدسون فعلًا.
أنابيب مقدسة فعلًا. فإكرامًا للأنابيب ومن يجني أرباحها وثرواتها، منعت البلدية أهالي الغيزانية من تجديد بيوتهم أو إعادة بنائها، لعل مكروهًا يصيبها، وتمهيدًا لتوسيع مشاريع خاصة بها. لقد منعت البلدية إصدار وثائق ملكية للبيوت القريبة من الأنابيب، لتجعل الباب مفتوحًا أمام سلب البيوت من قاطنيها، في أي لحظة شاءت. وهكذا يظل الأفراد يتساءلون بمنطق سليم: كنا نسكن نحن وآباؤنا على هذه الأرض قبل الأنابيب، فكيف أصبحت هي أحق منا بالأرض وبالوطن؟ إنهم لا يعلمون منطق التاريخ، وأن الحق يؤخذ ولا يُعطى.
في شهادته على واقع الأحوازيين تحت الاستعمار الإيراني، يصف الكاتب والباحث الأحوازي حسام المطوري معاناة سكان القرى في الغيزانية بأنها “صورة مصغرة من واقع الاحتلال وسياساته الاستعمارية”. ويؤكد المطوري في حديثه لمعهد الحوار على ضرورة وضع معاناة الأحوازيين في الغيزانية ضمن إطار أوسع يشمل القضية الأحوازية برمتها، والحياة التي يعيشها الأحوازيون تحت وطأة الاستعمار الإيراني وسياساته المتعاقبة.
ويشير إلى “أن سبل العيش باتت مستحيلة في الأحواز بعد تدمير الاقتصاد التقليدي الذي كان يعتمد على الزراعة وتربية المواشي والصيد وزراعة النخيل.” ويعزو هذا التدمير إلى سياسات الاحتلال والاستعمار التي تمثلت في: “تجفيف الأهوار، مما أدى إلى تدمير مصدر حيوي للرزق والبيئة، وبناء حوالي 138 سداً على الأنهار الأحوازية، وحرمان الأراضي الزراعية من المياه، وسلب ومصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية لصالح مشاريع قصب السكر الاستعمارية، ومنع تدفق المياه بكميات كافية إلى الأنهار الأحوازية.”
ويعتبر المطوري “أن هذه السياسات أدت إلى تدمير شبه كامل للاقتصاد التقليدي. وفي ظل غياب البديل من قبل الاحتلال الإيراني، وجد الإنسان الأحوازي نفسه أمام بطالة مطلقة. ولم يقتصر إقصاء الأحوازيين على القطاع النفطي والإداري فحسب، بل امتد ليشمل سيطرة المستوطنين التامة على كافة القطاعات الصناعية والإدارية. كما باتت الأسواق الحرة في قبضتهم. وفي ظل هذه الهيمنة أصبحت البطالة سمة بارزة في الحياة الأحوازية، تاركة أمام الأحوازي خيارات اقتصادية محدودة. ففي محاولة لتأمين سبل العيش، يضطر البعض للعمل على هامش الأسواق الحرة، نظراً لصعوبة المنافسة أو الدخول إليها بشكل كامل بسبب سيطرة الاحتلال والمستوطنين عليها. وقد دفع هذا الوضع شريحة كبيرة من المجتمع إلى سلوكيات اقتصادية شاذه، مثل تجارة المخدرات، والسرقة، وتهريب الأسلحة. كما اضطر آخرون إلى السفر خارج الوطن، إلى دول مجاورة كالعراق أو عُمان أو الكويت، بحثاً عن فرص عمل.”
ويختتم الباحث الأحوازي حديثه بالقول إن الشعب الأحوازي يعاني من التمييز على أساس هويته العربية والقومية. ويؤكد أنهم يُعاملون كـ “مدانين ومميزين سلبًا ومنبوذين ومبعدين وتُمارس عليهم سياسات التهميش والحرمان من حقوقهم الأساسية”. ويشير إلى “أن السياسات الهوياتية والثقافية التي تهدف إلى إبقاء العربي في موقع أدنى، حتى لو كان يتمتع بأعلى الكفاءات، تساهم في بقائه على الهامش كعامل مستعبد يفتقر لأي حقوق إنسانية. أجل تلك هي بعض جوانب الحياة في ظل الاستعمار الإيراني الذي قضم الأرض/الوطن ومن عليها”.
رحيم حميد، باحث في معهد الحوار للابحاث والدراسات